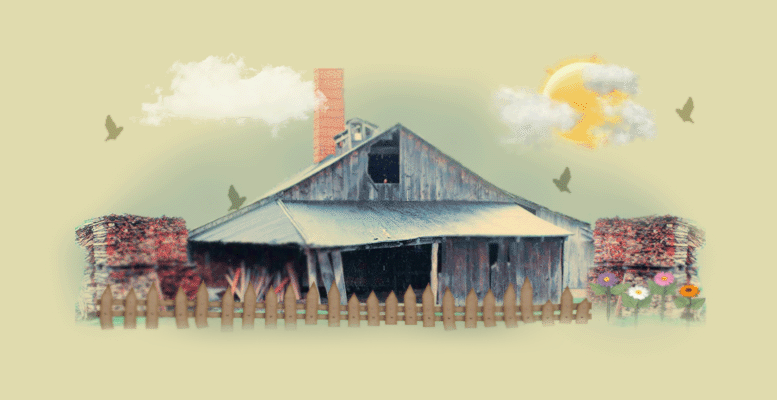ج ـ خلق الأرض
سورة الملك(67)
قال الله تعالى: {هوَ الَّذي جعلَ لكم الأَرضَ ذَلُولاً فامشوا في مناكِبِها وكُلُوا من رِزْقِهِ وإليه النشور}
سورة النحل(16)
وقال أيضاً: {وألْقَى في الأَرضِ رَواسِيَ أن تَمِيدَ بكم وأَنهاراً وسُبُلاً لعلَّكم تهتدون}
ومضات:
ـ جعل الله تعالى الأرض مذلَّلة بين يدي الإنسان ليعيش عليها ويقتات من خيراتها، ويذكر أنها مجرَّد مَعْبَرٍ له للوصول إلى يوم البعث والقيامة.
ـ تتجلَّى الحكمة الإلهية في خلق الجبال في أهميتها العظيمة لحفظ توازن الأرض ومن عليها.
في رحاب الآيات
إن الناس لطول إلفتهم الحياة على هذه الأرض، ولسهولة استقرارهم عليها، وسيرهم فيها، واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها، ينسَوْن مدى الإبداع والإعجاز فيها، ويتغافلون عن نعمة الخالق في تذليلها لهم وتسخيرها لمنفعتهم. والقرآن الكريم يذكِّرهم بهذه النعمة العظيمة، ويبصِّرهم بها، في هذا التعبير الَّذي يدرك حقيقته كلُّ جيل بقدر ما ينكشف له من علم عن هذه الأرض الذَّلول. ولكي نفهم معنى كلمة (ذَلول) وكيف أن الله تعالى ذلَّل الأرض وسخَّرها للإنسان لتوفير المنافع الدنيوية له، علينا أن نجري دراسة عن حجم الأرض وتكوينها الجيولوجي، وأهمِّية دورانها حول نفسها وحول الشمس بالنسبة لاختلاف الليل والنهار، وتغيُّر الفصول على مدار العام، وكذلك ما تحتويه من خيرات وأرزاق، وما يحكمها من القوانين والأسباب لقيام الحياة على وجهها. فما إِنْ نتفهَّم أهمِّية ذلك كلِّه حتَّى ندرك عظمة الخالق المنشئ، في تذليل تلك الكتلة الجبَّارة للإنسان؛ يسرح فيها ويمرح كيفما شاء، ويزرع ويحصد، ويبني ويشيِّد، وهي بين يديه ليِّنة العريكة كالطفل المستكين الوديع. ومع ذلك فهي تبقى مملوكة أبداً لخالقها ومبدعها، يبقيها ما شاء لها البقاء، ويفنيها حين يشاء لها الفناء، ويزلزل بعضاً منها لتبتلع مدناً بكاملها، أو يأمر جوفها بالانفجار، فتثور البراكين الَّتي تدمِّر ما فوقها وما حولها، وهكذا إلى أن يحين أجلها، فتفنى وتزول إيذاناً بالبعث والقيامة. وأمام تصريف الله لملكه يبقى الإنسان صغيراً بنفسه، كبيراً بصلته الوثيقة بالله القدير المتعالي.
والنصُّ القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليَعِيَها كلُّ فرد وكلُّ جيل بالقدر الكافي، ليشعر بيد الله وهي تتولاه وتتولى كلَّ شيء حوله، والَّتي لو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختلَّ هذا الكون، وبمقدار ما يعي الإنسان هذه الحقيقة يلبِّي دعوة الرحمن بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه فيها. والرزق هنا أوسع مدلولاً ممَّا يتبادر إلى أذهان الناس؛ إذ أنه لا يقتصر على كسب المال، وإنما يتعدَّاه ليشمل استثمار كلِّ ما أودعه الله في جوف هذه الأرض من الأرزاق المخبوءة، من معادن صلبة وسائلة وغيرها. على أنَّ الرزق مقدَّر من قبل الله بزمن محدَّد في علمه وتدبيره، فإذا انقضى هذا الزمن كان الموت، وكان النشور والرجوع، فإلى أين المصير إن لم يكن إليه؟ وكيف يكون لغيره والمُلك بيديه، ولا ملجأ منه إلا إليه، وهو على كلِّ شيء قدير؟.
وتمضي الآيات الكريمة في عرض بعض دلائل الإعجاز في الكون؛ فتقرِّر أن الجبال الرَّواسي تحفظ توازن الأرض، فلا تميد ولا تضطرب. وحفظ التَّوازن يتحقَّق في صور شتَّى، فقد يكون توازناً بين الضَّغط الخارجي على سطح الأرض والضَّغط الداخلي في جوفها، وهو يختلف من بقعة إلى أخرى. أو يكون بروز الجبال في موضع ما معادلاً لانخفاض الأرض في موضع آخر. وقد ثبت علمياً أن للجبال جذوراً في أعماق الأرض وظيفتها حماية طبقاتها من التحرُّك، وحفظ توازنها، حيث أن الطبقة الصُّلبة من القشرة الأرضية ترقد على طبقة لـيِّنة زَلِقَة ولو كان السَّطح السُّفلي للطبقة الصُّلبة مستوياً وكذا السَّطح العلوي للطبقة اللـيِّنة لانزلقت الأرض من تحت أقدامنا وبيوتنا ولَمَادَت ولما استقرَّ لنا قرار ولما صلحت الأرض للعيش عليها. وقد أثبت العلم أن الجبال مغروسة في باطن الأرض لتقوم بمهمة التثبيت كما هو شأن الوتد بالنسبة للخيمة، وما يظهر منها إلا الثُّلُث، والثُّلُثان في باطنها، وقد عبَّر القرآن الكريم عن تلك الجذور بالأوتاد في قوله تعالى: {أَلَم نجعلِ الأَرضَ مِهاداً * والجِبال أوْتَاداً} (78 النبأ آية 6ـ7).
وفي ذكر السُّبُل في الآية الكريمة وهي الطُّرُق النافذة السالكة في الجبال الَّتي تفصل بين كتلها الضَّخمة العالية؛ دلالةٌ على حكمة الصَّانع الَّذي لم يترك الجبال كتلاً هائلة من الصُّخُور والأحجار، تحجز البلدان والأمصار وتعزل البشر، بل شقَّها وجعل فيها مسالك يستطيع الإنسان السَّير عليها والانتقال عبرها من مكان إلى آخر، لينتفع في تجارته وشؤون حياته، وليتمكَّن الإنسان من إنشاء العلاقات الطيِّبة مع أخيه الإنسان في المجتمعات الأخرى، ولولا ذلك لما انتشر الناس في أرجاء الأرض، ولما استفادوا من كلِّ خيراتها.
وقد ورد ذكر الأنهار في الآية مع الجبال لتوجيه الأنظار إلى العلاقة الوطيدة بينهما لأن الجبال غالباً ما تكون بطونها مخازن للماء ومنها تتفجَّر الأنهار، لكونها مساقط الثلوج والأمطار.
وظواهر الأرض عموماً تشير بوضوح إلى أنها قد صُمِّمت لتكون صالحة ليحيا الإنسان مستريحاً على ظهرها، مستمتعاً بخيراتها، بدليل قوله تعالى: {والأَرضَ فرشْناها فنِعْمَ الماهِدُون} (51 الذاريات آية 48) والفراش هو المكان المعدُّ لاستلقاء الإنسان وراحته.
وفي ضوء هذه النُّصوص المعجزة، وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة، الهائلة المدى، في أجواء السماء، وفي آماد الأرض، وفي أعماق الخلائق، يهتف القرآن بالبشر ليتَّجهوا إلى خالق السماء والأرض، متجرِّدين من كلِّ ما يثقل أرواحهم ويقيِّدها، متحرِّرين من الأغلال الَّتي تشدُّ النفس البشرية إلى هذه الأرض، وتثقلها وتأسرها عن الانطلاق في رحاب التوحيد والعبودية لله الواحد الأحد. منقول